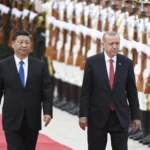إنّ العبدَ، وإن عجز عن تلاوةِ جملةِ القرآن الكريم آناءَ الليلِ وأطرافَ النهار، فحسبُه أن يُلازمَ من سُوَرِه سورةً واحدةً، فإنّ في كلِّ سورةٍ من أنوار الهدايةِ وفيوض الرحمة ما لا يحرمه من نصيبه، بل يجدُ فيها — على قدرِ سِعةِ فهمه وصِدقِ قبوله — خُلاصة مقاصدِ الكتابِ كلِّه. وكذلك الشأنُ في كتاب الكون؛ فليس في طوق ابن آدم أن يحيط علماً بجميع فنونِ العلوم وصنوف المخلوقات، غير أنّ من أخلص النظر في بابٍ واحدٍ من أبواب هذا الوجود، وأطال فيه فِكرَه وتأمّلَه، أُعطي من دروس الكون وعِبَره ما يكون كأنّه زبدةُ الجميع وخُلاصتُه.
فالذي فطر الإنسانَ من نطفةٍ ثم سوّاه رجلاً، هو الذي تفضّل عليه فعرّفه بنفسه، وأطلعه على مبدئه ومعادِه، وبيّن له سرَّ خلقه وغايةَ وجوده. وقد خاطبه بخطابين عظيمين: أحدهما من طريق الوحي والكتبِ المنزّلة، والآخر من طريق ما بثّه في الآفاق والأنفس من آياتٍ مبثوثة، تُتلى باللسان الكونيّ لكلّ من فتح سمع قلبه وبصر بصيرته. فالقرآن كتابٌ مقروء، والكون قرآنٌ منظور؛ وكلاهما كلام ربٍّ واحد، تفرّق تجلّيه بين لفظٍ يُسمع وآياتٍ تُشاهَد.
فإذا كان لكلّ متكلّمٍ سجيةٌ في البيان، ولكلّ بليغٍ مسلكٌ في الخطابِ وأسلوبٌ يختصّ به، أفلا يكون لكلامِ ربّ العالمين — جلّت عظمتُه — طابعٌ واحد يُعرَف في كتابه المقروء كما يُلمَس في كتابه المفتوح في صفحة الأكوان؟ بل كما يستدلّ السامع الخبير بألحان الموسيقيّين على صاحب اللحن من أول نغمة، كذلك المؤمن إذا تردّد بين تلاوةِ القرآن وتأمّل الكون، عرف في كليهما نفساً واحداً، وأسلوباً واحداً، فيوقِع قلبَه على وفق تلك الأسماء والصفات، ويطابق وجدانَه على ميزان ذلك الخطاب الإلهي.
١. الجَامِعِيَّةُ وَانْطِبَاعُ الكُلِّ فِي الجُزْءِ
من أعجب ما يُرى في القرآن الكريم أن أصوله الكبرى ومعانيه العظمى قد انطبعت في كلّ سورة من سُوَره، بل في كلّ آيةٍ من آياته، بل في كل كلمة، بل في الحرف الواحد من حروفه؛ حتى قال أهل الذوق والكشف: إنّ القرآنَ كلَّه في الفاتحة، والفاتحةَ في البسملة. فكأنّ القرآن صورةٌ واحدةٌ عجيبة، إذا قُسِّمَت أجزاؤها ظهر في كل جزء — وإن صغر — مثالُ الكلّ ورسمُه، على وجه الإيجاز والاختصار.
وفي عالم الخلق نظير ذلك: فما من شجرةٍ باسقةٍ إلا وقد أودِعَت حقيقتُها في حبّةٍ صغيرة أو نواة، تحمل نوعَها ووصفَها وطعمَ ثمرِها ورائحة أزهارِها، ولو فُصِّلت لظهرت صورة الشجرة كلّها طيَّ تلك الحبّة. وكذلك شأن الإنسان؛ فإنّ الشفرة الواحدة من سلسلته الوراثية تحمل خبر تكوينه من أوّله إلى آخره؛ فكأنّ الخلية الواحدة من خلاياه مرآةٌ لجسده كلّه، كما أنّ الآية الواحدة من كتاب ربّه مرآةٌ لرسالته كلّها.
والحروف المقطّعة التي في أوائل السور مثالٌ بديع في هذا الباب؛ فقد نظر فيها أهلُ العلم قديماً، فوجدوا لها مناسبةً عجيبة بما بعدها من السور، ورأوا فيها كالمفتاح لمعاني السورة، وكالرمز الكليّ لطبيعة ما يُتلى بعدها. فهي — في جانب اللفظ — حروفٌ متفرّقة، وفي جانب المعنى كالشيفرةِ الجامعة أو النسق الكوديّ الذي أُدمِجَت فيه حقائقُ السورة على جهة الإشارة والإجمال.
وكذلك العالَم الأعلى والأدنى؛ فإنّ العلماء إذا ضربوا بأبصارهم في ملكوت السماوات والأرض، وأطالوا النظر في حركة الأفلاك أو في سلوك الجسيمات الدقيقة، وجدوا أنّ القوانين التي تسيّر المجرّات هي نفسُها — في جوهرها — تلك التي تمسك الذرّة وتدبّر مسارها. ومن هنا نشأت عندهم فكرةُ توحيد القوى، ثم نظريةُ «كلّ شيء»، وإن لم يهتدوا بعد إلى كنهها وحقيقتها؛ غير أنّ هذه النزعة إلى جمع الكثرة في قانون واحد، ووحدة النظام في صورٍ متعدّدة، لا تزيد المؤمنَ إلا يقيناً بأنّ وراء هذا الكون إلهاً واحداً جمع شتات الصور بوحدة الحكمة والإرادة.
ومن هنا أيضاً، من لم يستطع أن يطوف بكلّ ميادين العلوم، ثم خصّ فنّاً واحداً من فنونها بالبحث والتحقيق، جاز أن يُعطى من دروس التوحيد والعرفان في ذلك الفنّ ما لو جمع ما في سواه لم يزد عليه، لأنّ المادةَ واحدةٌ في الأصل، وإنما تعدّدت صورُها ومظاهرها.
٢. الدِّقَّةُ وَالعُمْقُ وَتَعَدُّدُ الطَّبَقَاتِ
القرآن الكريم إذا تُلي على عَجَل، وبغيرِ تدبّرٍ ولا إعمال فكر، بدا لمن سمعه في غاية السهولة والعذوبة؛ ألفاظُه ليّنة على اللسان، رقيقةٌ على الأذن، تسري في القلب سريان الماء الزلال في العروق والأغصان. فإذا أقبل عليه ذو فكرٍ ثاقب، وعقلٍ متأمّل، وقلبٍ مستنير، انفتحت له من أبعاد المعاني وآفاق الدلالات ما يحيّر الألباب، ويُغرق العقول في بحارٍ لا ساحل لها.
وقد جاء عن سيّد الخلق صلوات الله وسلامه عليه أنّه قال: «إنّ للقرآنِ ظاهراً وباطناً، ولكلّ حدٍّ مطلعاً»، فدلّ على أنّ لكلّ آية بساطاً من المعنى يدركه عامّة المؤمنين، ثم وراءه لُطَفاً وإشاراتٍ ودقائق لا ينالها إلا من تهيّأ لها بنور العلم وصفاء القلب. فربّ آيةٍ واحدةٍ يستنبط منها الفقيه أحكاماً وفرعيات، ويستخرج الأصوليّ منها قواعد ومسالك، ويأخذ منها العارف بالله إشاراتٍ في السير إلى ربّه، ويرى فيها صاحب النفس اللوّامة مواعظَ وزواجر، ويجد فيها المربّي قوانينَ للإصلاح الاجتماعي، والمؤرّخ سنناً للأمم في علوّها وسقوطها.
وهذه الخاصية عينُها نلمحها في كتاب الكون أيضاً؛ فإنّ من نظر إلى ظاهر الطبيعة — من نضرة الروض، وبهاء السماء، وتناسق الألوان والأصوات — لم يملك إلا الإعجاب والتلذّذ بما ترى العين وتسمع الأذن. فإذا تجاوز هذا الظاهر إلى أن يسأل: كيف تجري هذه السنن؟ وكيف نُسّقت هذه المقادير في الذرّة والمجرة؟ وكيف التقت القوى المختلفة على قانون واحد؟ بدا له من الدقّة ما يبهر، ومن الغور ما لا يُدرَك قرارُه.
فانظر — مثلاً — إلى خليةٍ عصبية واحدة في جسم الإنسان؛ كم اشتغل بها أهل الطب والكيمياء والأعصاب والهندسة الحيوية دهوراً طويلة، وما يزالون إلى اليوم لا يقفون إلا على طرفٍ من أطراف سرّها؛ فإذا كشفوا باباً من أبوابها، انفتحت لهم وراءه أبوابٌ كثيرة، كأنّهم كلما أزاحوا ستراً ظهر لهم دونه سترٌ آخر أغلظُ منه وأحجب. وهكذا شأن الباحث في أسرار الحياة عموماً؛ كلما ظنّ أنّه بلغ الغاية، إذا به لم يزِد على أن قطع خطوةً في الطريق الطويل، وكأنّه يهبط في بئرٍ لا يُدرَك قعرها.
ومن سنّة الله في كتابه المقروء والمنظور جميعاً أنّه لا يبوح بأسراره لكلّ غافلٍ ولا لكلّ متلاعب؛ بل لا بدّ من أدب الطلب، وصدق التوجّه، وطهارة الباطن. فكما أنّ آيات القرآن لا تُفتَح خزائنُها إلا لمن أقبل عليها بتلاوةٍ وتدبّر، وخشوعٍ وامتثال، كذلك آيات الكون لا يُكشَف وجه الحكمة فيها إلا لمن لزم سبيل البحث الأصيل والصبر الطويل والتواضع للحقّ، لا من اتّخذ العلم سلّماً للكبرياء والطغيان. ومن هنا كان العلم الحقّ ضرباً من العبادة، كما أنّ العبادة على وجهها ضربٌ من المعرفة؛ يكمّل كلٌّ منهما صاحبه، ويفضي أحدهما إلى الآخر.
فإذا اجتمع للعبد نصيبٌ من نور الوحي، ونصيب من نور العقل والتجربة، رأى في القرآن والكون معاً عمقاً واحداً، ووجد أنّ كليهما يدعوه إلى أن يخلع نعل الغرور على عتبة القدس، ويدخل ميدان المعرفة خاشعاً مطمئناً، لا مدّعياً ولا متكبّراً.
٣. النَّغَمُ وَالتَّناسُقُ وَمِيزَانُ الإِيقَاعِ
القرآن الكريم، إذا جرى على ألسنة القرّاء حقَّ تلاوته، خرج كأنّه لحنٌ سماوي، تلتقي فيه الحروفُ والكلماتُ على نسقٍ عجيب من الانسجام؛ لا إفراطَ فيه ولا تفريط؛ لا رتابة مملّة، ولا قفزات منفّرة. بل ترى آيَه تتعاقب تعاقب الأنفاس المنتظمة في صدرٍ سليم، وترى فواصلَه تتوالى على أذن السامع توالي نقرات القلب على ميزانٍ واحد مستقيم. ومن استمع إلى آياتٍ مثل: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ وجد في جرسها شيئاً من عظمة ما تصف، وفي تناسق الحروف رشحاً من جلال الخلق نفسه.
وهذا الإيقاع الرحمانيّ، وهذا النَّغَم المحكَم، له في الفطرة صدىً يجيبُه؛ فكأنّ في روح الإنسان وتراً خفياً إذا ضُرِبَت عليه نغمات الوحي تجاوب معها واهتزّ، كما تهتز الأوتار المتناغمة إذا قُرِع بعضُها. ومن هنا ترى الطفل الصغير أو الأميّ الذي لا يفهم ألفاظ القرآن، ومع ذلك يخشع ويأنس لسماعِه، لأنّ الروح تستمع إلى ما وراء الحروف من الميزان والانسجام، لا إلى المعنى الظاهر وحده.
وكذلك الكون — في جريانه وسيره — مسرحٌ واسع لهذا النَّغَم الكونيّ. فانظر إلى تعاقب الليل والنهار، وإلى انتقال الفصول من ربيعٍ إلى صيفٍ إلى خريفٍ إلى شتاء؛ تجد دورةً لا تدور في مكانها، بل تمضي قدُماً في خطٍّ حلزوني صاعد، كالسائر الذي يدور حول الجبل وهو في كل دورةٍ أعلى من أختها. وانظر إلى حركة الكواكب حول الشموس، والشموس في أفلاكها، ترى كوناً يطوف كأنه في طوافٍ لا ينقطع؛ كلّ ذرّة فيه تسبّح بحمد ربها في زمنها ومكانها ووزنها. فكما أنّ للقرآن مقاماً وإيقاعاً، كذلك للكون نغمٌ وسيرٌ على نسقٍ لا يختل.
والنفس البشرية تشهد بذلك؛ فهي تسأم من السكون الطويل، كما تسأم من الفوضى والاضطراب. تحبّ الحركةَ المنظَّمة، والتجدّد الذي لا يقطع الأصل ولا يفسد النظام. ولهذا يطمئن قلبها لتلاوة حسنة تُراعى فيها مخارج الحروف ومقادير المدود، كما يطمئنّ لنسيم السَّحَر، وصوت المطر الهاطل، وخرير الجداول؛ لأنّ في كلٍّ منها شيئاً من «إيقاع الربّ» في خلقه وخطابه.
٤. مَنْهَجُ التَّرْبِيَةِ وَأَدَبُ التَّهْذِيبِ
كلٌّ من كتاب الله المقروء، وكتابه المنظور، ليس مجرّد عرضٍ لمعلومات وأخبار، بل هو منهجٌ محكم في تربية الإنسان وتهذيبِه، وإخراجِه من ظلمات الجهل والهوى إلى نور العدل والحكمة. فالقرآن إذا خاطب، خاطب بقوّة الحقّ لا بتردّد المتحيّر، وبيّن أنّ للخير طريقاً واحداً لا يلتبس بغيرِه، وأنّ للباطل — وإن كثرت طرقه — نهاياتٍ كلّها خسران.
والكون أيضاً يربّي الإنسان على هذا المعنى نفسِه؛ فسنن الطبيعة لا تجامل أحداً؛ من ألقى نفسَه من شاهقٍ سقط، مؤمناً كان أو كافراً، ومن وضع يده في النار احترقت، مطيعاً كان أو عاصياً. فالرسالة واحدة: أنّ الوجود مبنيّ على قوانين ثابتة لا تنكسر لمراد الهوى، وأنّ السلامة في الطاعة، والهلاك في المخالفة. وكأنّ الكون يقول للإنسان كما يقول له القرآن: لستَ ربّاً تشرّع، بل عبدٌ تكلَّف؛ ولستَ مالكَ الأمر، بل مأمورٌ ومبتلىً تُختبر.
ومن تأمّل في مسيرة العمر رأى هذا بأوضح بيان؛ فإنّ الشيوخ الذين قاسوا تقلّبات الدنيا، وجُرّبوا في ميادينها، تجد فيهم غالباً من الوقار والسكون، ومن التسليم لأمر الله، ما لا تجده في كثيرٍ من الشباب المندفعين؛ لأنّهم تعلّموا من مدرسة الحياة أنّ العناد لسنن الله في الشرع والكون لا يزيد صاحبَه إلا كسراً وندماً، وأنّ أطيب ما يثمره العمر هو الطاعة والاستسلام لربّ العالمين.
فالقرآن والكون يلتقيان في هذه التربية الجامعة؛ كلاهما يقرّر للإنسان أنّه فقير إلى ربّه في كلّ شيء، عاجز عن دفع الضرّ وجلب النفع بنفسه، وأنّ عزّه كلّه في عبوديّته، لا في دعوى الاستغناء. فإذا عقل العبد هذا الدرس، استقامت له الحياة في ظاهرها وباطنها، وصار يقرأ آيات ربّه في المصحف كما يقرأها في نفسه وأيامه وأقداره.
إِشَارَةٌ خَاتِمَة
وهكذا، من تأمّل مليّاً في أساليب الخطاب في القرآن، ثم نظر في أساليب التدبير في الكون، تبيّن له أنّ المتكلّم في الكتابين واحد، وأنّ نفس الألوهيّة واحد في الكلمة وفي الكون. فكما أنّ الحروف والآيات في المصحف تشهد لمنزِّلها، كذلك الذرّات والأفلاك في الفضاء تشهد لمبدعها؛ وما على القلب إلا أن يجمع قراءتَيْهما، فيزداد يقيناً على يقين، ونوراً على نور.