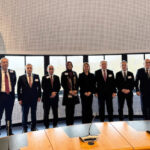بقلم: ياوز أجار
يواجه العالم الغربي، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، منذ عقود موجات متتالية من الهجرة القادمة في معظمها من الجغرافيا الإسلامية. وغالبًا ما تُفسَّر هذه الظاهرة بدوافع اقتصادية، غير أنّ جذورها الحقيقية تكمن في القمع السياسي، والإقصاء الأيديولوجي، وحالات عدم الاستقرار المزمنة التي تعاني منها تلك المناطق. واللافت أنّ شريحة واسعة من هؤلاء المهاجرين تنتمي إلى الفئات المتعلمة، والنخب الفكرية، وأصحاب الكفاءات المهنية العالية.
في المراحل الأولى، نُظر إلى هذه الفئات بوصفها عنصرًا يسدّ فجوات سوق العمل، ويسهم في دعم قطاعات الإنتاج والخدمات في الدول المستقبِلة. غير أنّ الهجرة، مع مرور الوقت، تجاوزت كونها متغيرًا اقتصاديًا لتتحول إلى ظاهرة سياسية وثقافية وديموغرافية شاملة. فقد حمل القادمون معهم تجاربهم التاريخية ورؤاهم القيمية، ودمجوها بالبنى المؤسسية للمجتمعات التي استقروا فيها، ما أسفر عن تشكّل واقع اجتماعي جديد.
ومع بدء هذا الواقع في الضغط على التوازنات القائمة داخل المجتمعات الغربية، تبدلت المقاربات. لم تعد الهجرة تُعدّ فرصة بقدر ما غدت ملفًا يُنظر إليه باعتباره مخاطرة ينبغي إدارتها. هذا التحول في الإدراك مهّد الطريق لصعود التيارات القومية واليمينية المتطرفة في أوروبا والولايات المتحدة، ولم يقتصر أثره على أطراف المشهد السياسي، بل امتد إلى الحكومات الوسطية التي أعادت النظر في سياسات الهجرة، سعيًا إلى ضبطها، بل ومحاولة وقفها عند منابعها.
هذا التحول الاستراتيجي انعكس بوضوح على نظرة الغرب إلى الشرق الأوسط. فالعلاقات التي بُنيت طويلًا مع أنظمة سلطوية تستند إلى أقليات ذات شرعية ضيقة، بدأت تُستبدل ببراغماتية جديدة تبحث عن ترتيبات أكثر اتساعًا من حيث القاعدة الاجتماعية. وهكذا، تقدّم “الاستقرار” على خطاب حقوق الإنسان ليغدو المبدأ الحاكم في سياسات الغرب الخارجية.
تُعدّ سوريا المثال الأبرز على هذا التحول. فمع تآكل نظام الأسد القائم على أقلية علوية والمتموضع ضمن محور روسيا–إيران، برزت الكتلة السنية، التي تمثل الغالبية الديموغرافية، كلاعب أساسي في المشهد السياسي. وفي هذا السياق، تشكّل توازن جديد للقوة بقيادة أحمد الشرع، الذي تعود جذوره إلى هيئة تحرير الشام.
وصفُ الشرع بوصفه “أداة” صرفة بيد الغرب أو إسرائيل يُعدّ تبسيطًا مخلًا بالواقع. صحيح أنّه جاء من خلفية إسلامية راديكالية، إلا أنّه أظهر في الوقت ذاته قدرة لافتة على قراءة التحولات الدولية، واعتمد نهجًا إداريًا لا يصطدم بشكل مباشر مع المتطلبات الأساسية للغرب. كما أن استيعابه لكوادر سنية ذات خبرة إدارية كانت تعمل في مؤسسات الدولة خلال عهد الأسد يعكس نزعة براغماتية واضحة في إدارة المرحلة.
في هذا الإطار، لا يبدو الدعم الغربي الحذر له أمرًا مستغربًا. ففي العلاقات الدولية، لا تُقاس المواقف بالماضي بقدر ما تُقاس بمدى الإسهام في استقرار التوازنات الراهنة. ويمكن قراءة التوترات الأخيرة مع الأكراد ضمن هذا السياق أيضًا. إذ يُنظر إلى الشرع، من زاوية غربية، باعتباره فاعلًا قادرًا على الحد من موجات هجرة جديدة. وقد يكون هو وفريقه بصدد توظيف هذه النظرة لخدمة أجنداتهم السياسية الخاصة.
هذا المشهد يفتح الباب أمام تساؤل أوسع: هل تستطيع المجتمعات الشرقية التي هاجرت إلى الغرب، من دون أن تقطع صلتها بجذورها، أن تستفيد من المناخ الليبرالي والتعددي في الغرب لإعادة ضبط النزعات الراديكالية في أوطانها الأصلية؟ إن تحقق ذلك، فقد نشهد في الشرق الأوسط ولادة واقع سياسي جديد، قائم على حكم الأغلبية، أكثر شمولًا، وقادر على التوفيق بين الإسلام والقيم الديمقراطية. غير أنّ هذا المسار ليس مشروعًا قصير الأمد، بل هو عملية تحول اجتماعي عميقة تحكمها قوانين اجتماعية وتتطلب الوقت والصبر.
تكمن المعضلة الأساسية في الشرق الأوسط في استمرار أنماط الحكم الشخصاني. أما أزمة النظام الدولي فتتمثل في تركّز القوة في قطب واحد أو قطبين: الولايات المتحدة في مواجهة روسيا والصين. من هنا، تبرز أهمية بقاء الاتحاد الأوروبي كقطب مستقل قادر على تعزيز قوته المؤسسية. وبالمثل، فإن عالماً إسلاميًا متوازنًا داخليًا يمكن، مع مرور الزمن، أن يتحول إلى قطب فاعل في النظام العالمي. فكلما تعددت الأقطاب، تراجعت مركزية القوة، وكلما توزعت القوة، ازداد الاستقرار.
قد يبدو العالم الإسلامي اليوم بعيدًا عن هذا الأفق، إلا أنّ تسجيل هذا التصور بوصفه هدفًا معياريًا يظل أمرًا ضروريًا. فالتاريخ السياسي، في كثير من الأحيان، لا يصنعه الواقع القائم بقدر ما تصنعه الأفكار والتوازنات التي جرى تخيّلها أولًا.