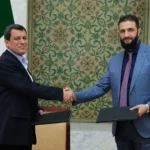تغيُّب أنقرة الملحوظ عن مشهد مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام ترافق مع حضور كردي لافت، في لحظة تعيد فيها أوروبا رسم معمارها الأمني والاقتصادي على أسس أكثر حمائية واستقلالية. هذا الغياب يطرح سؤالاً حاداً: أين ستقف تركيا في «أوروبا الجديدة» التي تتبلور بين واشنطن وبروكسل وموسكو وبكين؟
أولاً: ميونيخ ٢٠٢٦… منصة تعيد توزيع الأدوار
مؤتمر ميونيخ للأمن تحول منذ نهاية الحرب الباردة من ملتقى حواري إلى ساحة تُختبر فيها اتجاهات النظام الدولي وتُعلن عبرها التحولات الاستراتيجية الكبرى. في دورته الثانية والستين، انعكس على جدول الأعمال وطبيعة المشاركين حجم الاضطراب الجيوسياسي، من حرب أوكرانيا إلى صعود الصين كقوة تكنولوجية وعسكرية منافسة، مروراً بالتوترات في الشرق الأوسط.
هذا العام، برزت ثلاثة محاور مترابطة في النقاشات: إعادة تموضع أوروبا دفاعياً أمام احتمالات تقلص المظلة الأميركية، وتحويل سلاسل الإمداد والتكنولوجيا المتقدمة إلى ملفات أمن قومي، وتزايد وزن الفاعلين من خارج الدول في ملفات مثل سوريا وغزة.
تغيّر وظيفة المؤتمر في الحسابات الأوروبية
باتت ميونيخ بمثابة «مقياس ضغط سياسي» لحرارة العلاقة عبر الأطلسي ولدرجة جدية الأوروبيين في المضي نحو استقلالية استراتيجية نسبية عن واشنطن. النقاش الدائر لم يعد فقط حول إدارة الأزمات، بل حول شكل البنية الأمنية والاقتصادية الأوروبية في العقد المقبل، وكيفية تقليل الاعتمادية على الولايات المتحدة والصين في الدفاع والصناعة المتقدمة.
ثانياً: تركيا… حضور بروتوكولي هزيل في لحظة مفصلية
في دورات سابقة، اعتادت أنقرة أن تكون حاضرة في الصفوف الأولى عبر رؤساء الجمهورية أو الوزراء المعنيين بالسياسة الخارجية والدفاع، مستثمرة ميونيخ كمنبر لمخاطبة الغرب والتفاوض في الكواليس. هذا العام، انقلب المشهد رأساً على عقب؛ غاب وزير الخارجية ووزير الدفاع عن الجلسات، ولم يُفعَّل الحضور السياسي على مستوى القيادة التنفيذية.
التغطيات الأوروبية والتركية أشارت إلى أن أعلى تمثيل رسمي تركي في القاعات المفتوحة كان محدوداً، في حين جرى الحديث عن وجود رئيس الاستخبارات إبراهيم قالين في لقاءات مغلقة ثنائية تتناول ملفات مثل غزة وسوريا والهجرة غير النظامية والأمن السيبراني، لكن دون انعكاس على صورة عامة لتركيا كلاعب مركزي في الجلسات العلنية.
كما أُعلن أن مشاركة وزير المالية كانت مقررة بصفته المتحدث التركي الوحيد في أحد النقاشات الاقتصادية، قبل أن يُستعاض عنه بمستوى أدنى ثم يُسحب هذا التمثيل في اللحظات الأخيرة، ما عزز الانطباع بأن أنقرة قررت خفض انخراطها العلني في المؤتمر، أو عجزت عن مواءمة أجندتها مع إيقاع الاجتماع.
دلالة الغياب عن قاعات النقاش
التغيّب الفعلي عن مؤتمرات رئيسية لا يمكن قراءته كمسألة بروتوكولية فحسب، بل كفجوة تمثيل في لحظة يجري فيها تحديث «قواعد اللعبة» في أوروبا: من أولويات الإنفاق الدفاعي إلى معايير الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. غياب الصوت التركي في هذه اللحظة يعني أن تصورات الآخرين عن دور تركيا في المعادلات الأمنية والاقتصادية ترسم من دون حضور مباشر من أصحاب الشأن.
ثالثاً: صعود مظلوم عبدي في المشهد الغربي
في مقابل الحضور الباهت الرسمي التركي، برز قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي كواحد من أكثر الأسماء تداولاً في الكواليس وعلى منصات الحوار. استقبلته وفود برلمانية أميركية وأوروبية، وعُقدت له لقاءات مع شخصيات سياسية بارزة ناقشت مستقبل شمال شرق سوريا، مكافحة تنظيم داعش، وترتيبات ما بعد الحرب في الإقليم.
تداولت وسائل الإعلام صوراً تظهره إلى جانب مشرعين أميركيين يضغطون لتمرير تشريعات تدعم الإدارة الكردية، وتقديمه بوصفه شريكاً في جهود الاستقرار ومحاربة الإرهاب، في الوقت الذي تصنف فيه أنقرة البنية التي يقودها في خانة التنظيمات الإرهابية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
هذا التباين بين تعريف تركيا لهذه القوى وبين طريقة استقبالها في المنابر الغربية يعكس إعادة صياغة «الهندسة الأمنية» في سوريا؛ حيث تسعى عواصم غربية إلى تثبيت أطر تعاون مع جهات محلية تراها فاعلة على الأرض، حتى لو أدى ذلك إلى تعميق التوتر مع أنقرة.
ما تكشفه ميونيخ عن موازين القوى في الملف السوري
من خلال هذه المشاهد، يتضح أن الفاعلين غير الدولتيين في الشرق الأوسط باتوا يتعاملون مع منصات مثل ميونيخ كقنوات إضفاء شرعية سياسية، بينما تجد دول كتركيا نفسها مضطرة لإدارة ملفاتها الأمنية عبر قنوات ثنائية ومغلقة، لا عبر فضاءات متعددة الأطراف ترسم الخطوط العامة للمقاربات الغربية. النتيجة هي تآكل قدرة أنقرة على التأثير في الخطاب السائد حول مستقبل سوريا والأمن الإقليمي، حتى لو بقي تأثيرها العسكري واللوجستي قوياً على الأرض.
رابعاً: الاتحاد الأوروبي… من «السوق المفتوحة» إلى الكتلة الحصينة
بالتوازي مع البعد الأمني، تعيش بروكسل تحولاً بنيوياً في الفلسفة الاقتصادية–الاستراتيجية يمكن وصفه بأنه تغيير في «البارادايم» أكثر منه إصلاحاً تدريجياً. النقاش عن «الاستقلالية الاستراتيجية» لم يعد شعاراً نظرياً؛ بل بات يعني بناء قدرة أوروبية على التحرك منفصلة عند الضرورة عن واشنطن، وتقليل الاعتمادية على الصين وروسيا في الطاقة والتكنولوجيا والدفاع.
يتجلى هذا التحول في حزمة سياسات صناعية وتجارية جديدة تقوم على تعزيز «التفضيل الأوروبي» في المشتريات الدفاعية والتكنولوجية، وتوجيه استثمارات ضخمة – تُقدّر بمئات المليارات وربما تريليونات اليورو على المدى المتوسط – نحو الصناعات الدفاعية، الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة والبنى التحتية الرقمية.
بهذا المعنى، تتجه أوروبا إلى نموذج أكثر حمائية وتكاملية داخلياً، يُعمّق السوق الموحدة ويقلص الفوارق التنظيمية والقانونية بين الدول الأعضاء، لتُبنى «كتلة اقتصادية–أمنية» أكثر صلابة في مواجهة الضغوط الأميركية والصينية معاً.
“نظام الشركة الأوروبية” وتعميق السوق الموحدة
في هذا السياق، تكتسب مشاريع مثل توحيد أطر قانون الشركات على مستوى الاتحاد وتسهيل حركة رأس المال والتكنولوجيا داخل الفضاء الأوروبي زخماً متزايداً، بما يشبه خلق «سوق داخلية ثانية» موازية ولكن أكثر انضباطاً واستهدافاً للقطاعات الاستراتيجية. بالتوازي، تُعاد صياغة سياسات المنافسة والدعم الحكومي للصناعة بحيث تسمح بتشكيل «أبطال أوروبيين» كبار في الدفاع والتقنيات الحرجة، قادرين على منافسة عمالقة الولايات المتحدة والصين.
خامساً: مخاطر تهميش تركيا في النظام الأوروبي الجديد
في ظل هذه التحولات العميقة، تبدو تركيا مهددة بالوقوف عند هامش المنظومة بدل أن تكون جزءاً من نواتها الصناعية–التكنولوجية. فالاتحاد الأوروبي يعيد ضبط قواعد التجارة والاستثمار، في حين لا تزال علاقات أنقرة مع بروكسل مؤطرة في نموذج قديم لجماعة جمركية لا يمنح تركيا مكاناً في آليات صنع القرار الجديدة ولا في تصميم أدوات «الاستقلالية الاستراتيجية.
تنامي سياسة «الأولوية للأوروبي» في المشتريات العامة، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقات النظيفة والتكنولوجيا عالية القيمة، يرفع تلقائياً عتبة الدخول أمام الشركات من خارج الاتحاد، بما في ذلك الشركات التركية التي كانت تستفيد من الانفتاح النسبي للسوق الموحدة. من دون تحديث عميق للإطار التعاقدي والقانوني بين الجانبين، ستجد تركيا نفسها مجبرة على التكيّف مع قواعد يضعها الآخرون، مع اتساع الفجوة في القدرة التنافسية والتأثير المؤسسي.
مفارقة الفرصة والانسداد
المفارقة أن الظروف الموضوعية تتيح لأنقرة فرصاً مهمة: أوروبا تبحث عن بدائل لسلاسل الإمداد الصينية، وتحتاج إلى شركاء قريبين جغرافياً، يمتلكون قاعدة صناعية متوسطة متطورة، وقادرين على الاندماج في شبكات الإنتاج الأوروبية، وهي مواصفات تنطبق على تركيا إلى حد بعيد.
لكن تحويل هذه الإمكانية إلى شراكات طويلة الأمد يقتضي تعزيز الثقة القانونية والمؤسسية، وتحسين مناخ سيادة القانون واستقلال القضاء، بما يمكّن المدافعين عن تعميق الشراكة مع تركيا داخل مؤسسات الاتحاد من مواجهة التيارات المتحفظة. ضعف هذه الركائز يسهّل دفع الملف التركي إلى هامش الأجندة الأوروبية، ويحوّل تركيا تدريجياً إلى «دولة جوار» أكثر منها شريكاً مدمجاً في المعمار الجديد.
سادساً: بين عضوية الاتحاد وسؤال التموضع الاستراتيجي
النقاش التركي الداخلي ظل لعقود أسير سؤال واحد: هل ستقبل أوروبا عضوية تركيا الكاملة أم لا؟ غير أن الواقع الراهن يشير إلى أن القضية الأهم لم تعد منصبّة على الشكل القانوني للعلاقة، بل على موقع تركيا العملي داخل منظومة أوروبية تتجه لتصبح أكثر تكتلاً واستقلالية في الأمن والاقتصاد.
في هذا الإطار، يصبح الغياب عن منصات مثل مؤتمر ميونيخ علامة تحذير على أن أنقرة لا تحجز لنفسها مقعداً مبكراً في طاولة رسم قواعد «أوروبا الجديدة». المطلوب هو صياغة مقاربة استراتيجية تتجاوز سجال العضوية إلى خطة اندماج وظيفي في الصناعات الدفاعية، سلاسل الإمداد التكنولوجية، وسياسات الطاقة والتحول الأخضر الأوروبية، مع موازنة ذلك بارتباطات تركيا الأطلسية ودورها داخل الناتو.
إن استمرار هذا النمط من التمثيل المنخفض في المنتديات الكبرى سيجعل السؤال الأكثر إلحاحاً ليس إن كانت تركيا ستصبح عضواً في الاتحاد يوماً ما، بل إن كانت قادرة على منع تحولها إلى طرف متلقٍ لقرارات تُتخذ في غيابها، في فضاء إقليمي تُعاد صياغة حدوده وموازين قوته.
الخلاصة
مشهد ميونيخ الأخير كشف فجوة آخذة في الاتساع بين إعادة تشكيل الأمن والاقتصاد الأوروبيين وبين تموضع تركيا التي غابت سياسياً بينما برز خصومها في الملف السوري. إذا لم تُترجَم فرص القرب الجغرافي والقوة الصناعية إلى استراتيجية اندماج مدروسة، فقد تجد أنقرة نفسها خارج قاعة صناعة القرار في «أوروبا الجديدة».